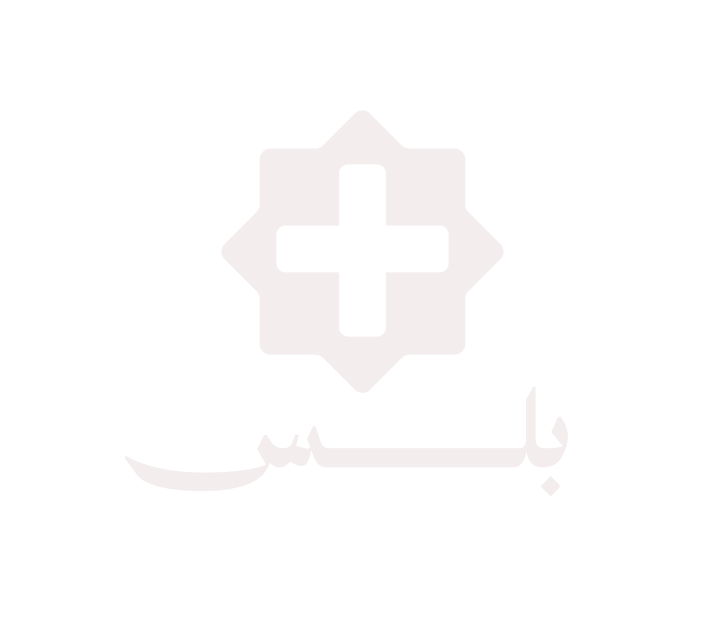في أواخر عام 2016 وبدايات عام 2017، شهدت مدينة حلب واحدة من أكثر المحطات إيلامًا في تاريخها الحديث، إذ أُجبر عشرات الآلاف من المدنيين في أحيائها الشرقية على التهجير القسري، وذلك عقب حصار خانق وقصف مكثف ودمار واسع طال الإنسان والمكان على حد سواء. ولم يكن هذا الخروج مجرد انتقال جغرافي من حي إلى آخر أو من مدينة إلى أخرى، بل كان اقتلاعًا قاسيًا من الجذور، وقطعًا مفاجئًا لمسار حياة كاملة تُركت خلف أبواب أُغلقت على ذاكرة مثقلة بالخوف والفقد.
ومع مرور ثماني سنوات على تلك الأحداث، ما تزال الذكرى حاضرة بقوة في وجدان الحلبيين، ولا سيما أولئك الذين حملوا مدينتهم معهم أينما ارتحلوا. فمن جهة، يرافقهم خوف دائم من تلاشي الذاكرة، ومن جهة أخرى، يسكنهم يقين راسخ بأن العودة، مهما تأخرت، تظل احتمالًا قائمًا لا يسقط بالتقادم.
وفي هذا السياق، يستعيد أنس العلي، أحد المهجرين من أحياء حلب الشرقية، لحظة الخروج قائلًا:
«في عام 2016، وبعد حصار خانق ودمار واسع، غادرنا المدينة، غير أن يقين العودة لم يفارقنا. خرجنا ونحن نضع الرجوع نصب أعيننا، فغادرت مع عائلتي خارج البلاد، خطوة إلى الأمام، وعشر خطوات إلى الخلف».
ويصف أنس سنوات التهجير بأنها مسافة طويلة بين الذاكرة والواقع، إذ بدأت صور حلب تتلاشى تدريجيًا، ذكرى بعد أخرى، قبل أن تعود بكل ثقلها عند لحظة الرجوع، مضيفًا:
«بعد التهجير، بدأت ذكريات حلب تخفت شيئًا فشيئًا، لكن ما إن عدنا، حتى عادت الذكريات كلها دفعة واحدة».
أما معن شنان، فيختصر تجربة التهجير بكلمة واحدة: الوجع. ويقول:
«عندما تهجّرت من حلب في نهاية عام 2016، لم أحمل معي سوى وجعي. تركت خلفي منزلًا وذكريات، وغادرنا دون أن نعرف إن كنا سنعود يومًا، أو حتى إن كانت حلب ستبقى موجودة».
ويرى معن أن التهجير لا يقتصر على مغادرة المكان فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى فقدان جزء من الذات، موضحًا:
«التهجير ليس مجرد ترك لمكان، بل هو أن تترك جزءًا منك خلف الباب، وأن تعيش سنوات معلّقًا بين ماضٍ لم يمت، ومستقبل بلا ملامح واضحة».
وخلال سنوات الغربة، كان كل خبر أو صورة عن حلب كفيلًا بإحياء مشاعر الفقد والنقص، إلى أن جاءت لحظة العودة بعد سقوط النظام البائد. غير أن هذه العودة حملت في طيّاتها تناقضًا مؤلمًا بين الفرح والألم، كما يعبّر معن بقوله:
«عندما عدت اليوم، عدت كما خرجت، لكن في قلبي فرح ممزوج بوجع عميق، وجع على كل ما خسرناه بهذه الطريقة».
ويصف معن حلب اليوم بأنها مدينة متعبة، لكنها ما تزال صامدة، قائلًا:
«عدت إلى مدينة جريحة، انكسرت لكنها لم تُهن. وأدرك أن العودة ليست نهاية الحكاية، بل بداية طريق طويل من الترميم… ترميم الإنسان أولًا، قبل إعادة بناء الحجر».
وهكذا، تبقى حلب، كما يقول أبناؤها، مدينة لا تعود إلا بأهلها. وقد عادوا اليوم لا ليستقروا فحسب، بل ليحكوا روايتهم، ويستعيدوا ذاكرتهم، ويؤكدوا أن ما جرى لن يُنسى، حتى لا يتكرر مرة أخرى.