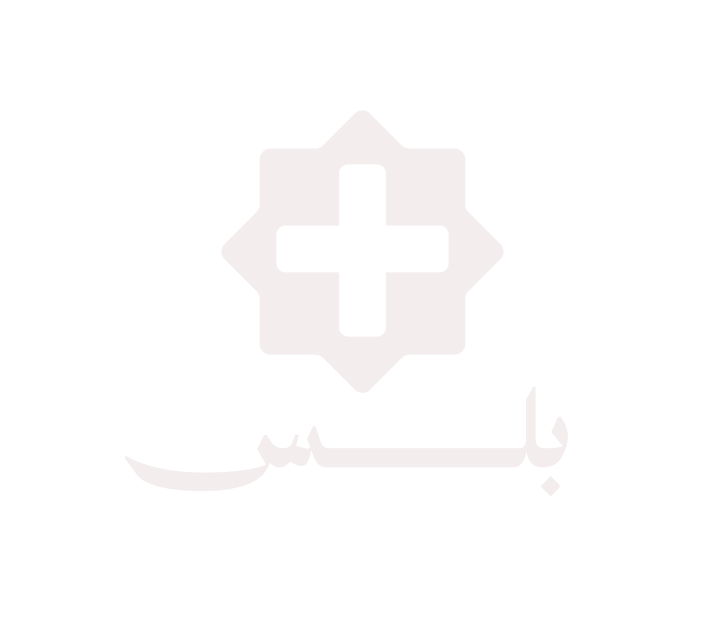بدا لي مناسبًا بعد مرور سبعة أعوام وشهرين على ذكرى انطلاقة الثورة السورية، أن يقع كتاب “قنديل أم هاشم المفقود” للكاتب عدي الزعبي بين يديّ – رغم أنه نشر منذ سنتين- لأن في الكتاب مراجعة للسنوات السبع الماضية وأثرها علينا كأفراد وجماعة.
يرتب الزعبي كتابه ترتيبًا زمنيًا ولكن ليس من البداية للنهاية، وإنما منذ العام 2015 عودة إلى العام 2011، وفي هذا الترتيب يكتسب الكتاب خصوصيته، فلو أن نصوصه كانت عكسية الترتيب، لكان من أنهى الكتاب شعر بانقباض ويأس، فيما يعيد استرجاع بداية حكايتنا كسوريين ثائرين أملًا أخفي في طيات الألم الذي تحمله النصوص اللاحقة زمنيًا.
يفتتح الزعبي كتابه بمجموعة نصوص عنونها “المنفى”، ويلحقها بقسم ثان “الثورة”. يتضمن القسم الأول نصوصًا عن منافي متعددة تنقل بينها الكاتب، مراقبًا ما جرى مع السوريين من حوله، ومعه هو شخصيًا بين بريطانيا وتركيا وعلى متن الطائرات وشواطئ البحار، تنقلنا النصوص بسلاسة وحساسية عالية ولغة مؤثرة بين عوالم مختلفة لمنافي ومشاعر متناقضة يختبرها السوري كل يوم.
لعل المميز في نصوص المنافي هو تفردها وجمعيتها في آن، فالتجارب الواردة في النصوص رغم ذاتيتها الشديدة وارتباطها بتجربة الكاتب التي لا يمكن أن تشبه تجارب الآخرين، إلا أنها في الوقت نفسه، تكاد تكون نسخة معدلة عن اغتراب الروح الذي يمكن تعميمه على الهاربين والناجين.
ولعل ما يجمع كل المشتتين في الأرض من السوريين هو الخوف من لحظة رحيل أبدي لأحبة تركوهم خلفهم في الداخل دون أن يستطيعوا وداعهم، وهو ما يمر به الكاتب، فيكتب مرثية بديعة في وداع جدته، مليئة بكل ما نخشاه ونعيشه من آلام الفقد اليومي السوري.
ينتهي القسم الأول، تاركًا القارئ منشغلًا بسؤال يلح علينا جميعًا: كيف وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم؟ يحاول القسم الثاني من الكتاب تقديم إجابة يجمعها من شهادة الكاتب وشهادات من التقى بهم خلال الثورة، ليلقي الضوء على جوانب محددة من العمل الثوري وقمع النظام. يبدو مناسبًا في هذا السياق افتتاح هذا الجزء بمقابلة أجراها الكاتب مع ناج من معتقلات الأسد، إلا أن غياب صوت الزعبي تمامًا عن هذا النص جعله غريبًا عن بقية أجزاء الكتاب لأن تقييمه وتعليقه على كل ما تبقى كان هو ما يجمع هذه النصوص التي قد تبدو للوهلة الأولى متفرقة وعشوائية.
الكتاب في الواقع حكاية كاتب سوري وجد نفسه في المنفى بعد انحيازه للثورة، لكن الحكاية هنا ترسم كما واقعنا السوري، فهي ليست منسابة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، بل تتقطع، وتنفصل، ثم تعود لتتصل وتتركب من تلك القطع الصغيرة من ذاكرة باتت بعيدة ولكنها ملحة وحاضرة لحلم بإسقاط الطاغية.
في جزء المنفى يستخدم الكاتب الضمائر المعبرة عن المفرد، فيما في قسم الثورة تغلب لغة الجماعة، فينتقل الكاتب من استخدام: أنا إلى نحن، ومن استخدام الياء إلى استخدام الـ”نا”، وفي ذلك دلالة على قدر من الأهمية: جمعتنا الثورة، فيما فرقتنا المنافي في بحث عن خلاص فردي لم نؤمن به أصلًا.
لا يقدم الكتاب أجوبة حاسمة على أسئلة تدور في ذهن الكاتب، بل يطرحها للقارئ للتفكر وإعادة النظر، وتبدو هذه الدعوة لإعادة النظر ضرورية بل وحاسمة اليوم لإكمال طريق الثورة بعد تقييم ما مر، وإعادة هيكلة الحلول والاستراتيجيات التي تمكن كلًا منا من الاستمرار من مكانه وفي مجاله.
علنا ذات يوم نحقق الوطن الذي حلمنا به والذي يختم الزعبي كتابه بجملة عنه قد تختصر الكثير: “نرى الوطن حديقة، ويراه الطاغية مقبرة”، على أمل أن تزهر الحديقة يومًا في القريب العاجل ويعود المنفيون ليضعوا الورود على قبور من رحلوا في غيابهم.